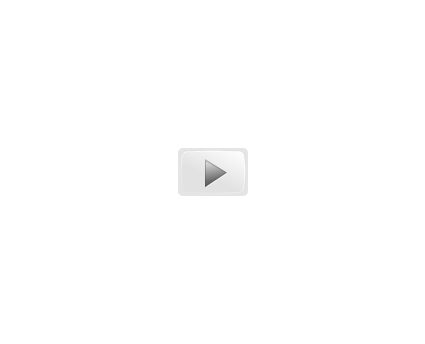Year 5/ Issue 175
Identificazione Di una Donna
إخراج: ميكلانجلو أنطونيوني.
إيطالي ـ فرنسي. إنتاج: أيتر فيلم (روما) وغومون (باريس) بالتعاون مع التلفزيون الإيطالي ـ القناة 2 (1982).
سيناريو: م. أنطونيوني، جيرار براش| مدير التصوير: كارلو دي بالما (تكنوفيزيون ـ تكنيكولور)| مونتاج: م. أنطونيوني || موسيقى: جيمس فوكس.
الممثلون: توماس ميليان، دانييلا سليفريو، كريستين بوسون، ساندرا مانتوليوني، جيانباولو سكارولا.
النوع: دراما اوتوبيوغرافية [ملون. المدة: 131د.]
نفي مايكلأنجلو أنطونيوني أن يكون فيلمه هذا من السيرة الذاتية من وجهة نظر بطله، ولكن وسيلة سرده تبقى ذاتية، والفيلم الذي نتابعه نستدل على أحداثه بتتبع ما يدور مع بطله. عدا عن أن هذه الشخصية الرئيسية التي تتولى البحث عن سحر وسر امرأة معينة هي من العمر والخبرة والمكانة الثقافية ما يجعلها أهلاً لثقتنا وبالتالي مناسبة لأن تتولى سرد الفيلم من وجهة نظرها أو سرد مشاعرها الذاتية.
«هوية امرأة» ـ العنوان تلخيص لسينما أنطونيوني التي كثيراً ما جمعت رغبة البحث الحارة المنطلقة من ذات البطل والتي تطال النساء اللواتي حوله أو بعض منهن. أنطونيوني ذاته يبدو باحثاً مثالياً عن ماهية المرأة أو ـ بالتحديد ـ هويتها. لكن على عكس فدريكو فلليني، لا يميل إلى الفانتازيا ويتجنب النماذج الحادة وعوضاً عنها يقدم حالات ذاتية واجتماعية تعكس أعماقاً إنسانية كاملة. كل فرد من أفراد أنطونيوني الرئيسيين، أو ربما غير الرئيسيين أيضاً، هو حالة قائمة بذاتها وقابلة للتصديق.
الفيلم هو عمق ذلك البحث. بطله نيكولو (توماس ميليان) مخرج أفلام، وصديقته «مافي» (دانييلا سيلفريو) هي المرأة التي يبحث عنها بعدما افتقدها. موضوع فيلمه القادم هو المرأة المثالية، والفيلم تسجيلي يريد عبره تحديد هوية تلك المرأة، لكن نيكولو لا يعرف بينه وبين نفسه ماهية تلك المرأة. كيف يمكن إذن تحقيق فيلم عن المرأة المثالية إذا لم يكن يعلم مواصفاتها؟ من دون وعي، وفي عناء بحثه عن صديقته (نعلم منذ البداية أنه قد طلق زوجته حديثاً) ثم في عناء محاولة التعرف عليها من جديد وقد التقاها، يخلط نيكولو بينها وبين الشخصية المثالية التي يبحث عنها، ثم وبيّنها لفيلمه. وإذ يفقدها من جديد يعود إلى دائرة البحث المفرغة.
نيكولو، مع نهاية الفيلم، يبدو قد اقتنع بعدم تحقيق ذلك الفيلم. عوضاً عنه أخذ يبحث في مشروع فيلم علمي ـ خيالي.
نيكولو قد يكون أحدنا، أو قد لا يكون ففيه نتعرف إلى اختلافاتنا لكننا فيه أيضاً نكتشف ـ نحن الرجال ـ القاسم المشترك الذي يجمعنا: البحث عن المرأة المناسبة. في جزء كبير منه يبدو البحث فارغاً، عبثياً أو غير ضروري. لكن أشكال وموجبات ذلك البحث سريعاً تتكامل بمساعدة أسلوب أنطونيوني الرزين ومدلولاته العميقة في كل مرة يرى المتفرج نفسه أكثر تعلقاً بماهية ذلك البحث وبالهالة العاطفية (الجنسية) التي تنفذ إليه وأحياناً تحركه.
عالم نيكولو ليس واقعياً. بحثه فيه خيطاً من ذلك العالم بكل تأكيد. والمشهد الذي يبدى لنا ذلك الخيط غير الواقعي أكثر من غيره هو الذي نراه فيه يبحث عن صديقته في مشهد على طريق منقطعة وكثيفة الضباب تمنعه عن الرؤيا. في المشاجرة التي يتم بعضها في ذلك الجو المضطرب ـ وقد سيطر عليه أنطونيوني سيطرة تامة مصمماً تنفيذاً مناسباً تماماً للحالة ذاتها ـ تكتشف هي ونكتشف نحن معها أن نيكولو يستغل اقترابها منه في سبيل إيجاد الشكل النسائي المناسب لفيلمه. الشكل وليس الممثلة. أنه، ولو كررنا، يبحث عن المرأة المثالية ويواجه في إغراء إزالة الحواجز بين المرأة المهتمة به والمرأة التي يريدها لفيلمه. بمعنى أن «مافي» حين أرادته، أرادته لنفسها وليس من أجل أن يجد فيها المرأة المثالية.
خلط المواقع عنده يتكرر حين يتعرف على الفتاة الأخرى أيدا (كريستين بوسون) بالرغم من كونها امرأة مختلفة الطباع والموقف الاجتماعي. أيدا تريد أن تصير امرأة أخرى لكن لا تدري أي امرأة تريد أن تصير، وبالرغم من هذه المعايشة غير المستقرة في ذاتها إلا أنها أدركت بدورها هو أن نيكولو هو أقل استقراراً منها.
هذا الثلاثي يؤلف في النتيجة قصة حب واحدة. لكن في الوقت الذي كانت فيه قصص الحب تعني الكثير في أي مجتمع، نرى أن نيكولو ومافي وأيدا والمخرج من ورائهم يقللون قصص الحب مدركين أن العصر الذي يعيشونه قد تغيّر وبتغيره ما عاد للحب مفعوله وصار حدوثه مناسبة لتبادل التصرفات من حوله ولفتح الأبواب المؤدية إلى الداخل (داخل الأنفس) أو إغلاقها. بالتالي قد يمر الحب دون التعرف عليه مثل المقطوعة الموسيقية الناعمة التي لا بد أن تمر على أذن كل إنسان لكن أصوات الضجيج من حوله والصخب الحياتي المتزايد قد يجعلها تمر دون أن يصغي إليها أو دون أن يسمعها أصلاً.
أنطونيوني يهتم جداً بالأصوات هنا، إنها عنصر إضافي فوق العناصر التي بها يصمم مشاهده: الدرج الحلزوني، البحيرة المنقطعة، الطرق الضبابية، أو بعض تصرفات أبطاله ـ وبالأخص تصرفات نيكولو الصغيرة (في بداية الفيلم) أو الكبيرة.
نيكولو قد يرفض أن يكون ضحية، لكنه ضحية شاء أو أبى: في المشهد الأول نراه يعاني، رمزياً، من آثار زوجه السابق عندما يحاول دخول شقته فإذا بصفارة الإنذار التي وضعتها زوجته ضد اللصوص تنطلق لأنه أساء طريقة فتح الباب. لاحقاً يعاني من مطاردته لــ(مافي) ومن تقربه لــ(أيدا)، لكن مثل الفيلم كله هذه المعاناة لها مبرران أحدهما عاطفي والآخر فني. مثل «نقطة زابرسكي» و«المهنة: مخبر صحفي» وغيرها من أعماله السابقة «هوية امرأة» فيلم عن محاولة رجل الخروج من ذاته بحثاً عن المرأة المناسبة في أكثر من رمز، ومثل تلك الأفلام الأخرى يرفع أنطونيوني الموضوع إلى مستوى الهاجس الشخصي في الوقت الذي يقدم فيلماً يدعو للتمعن مرة ويدعو للتمعن أكثر في كل مرة لاحقة.